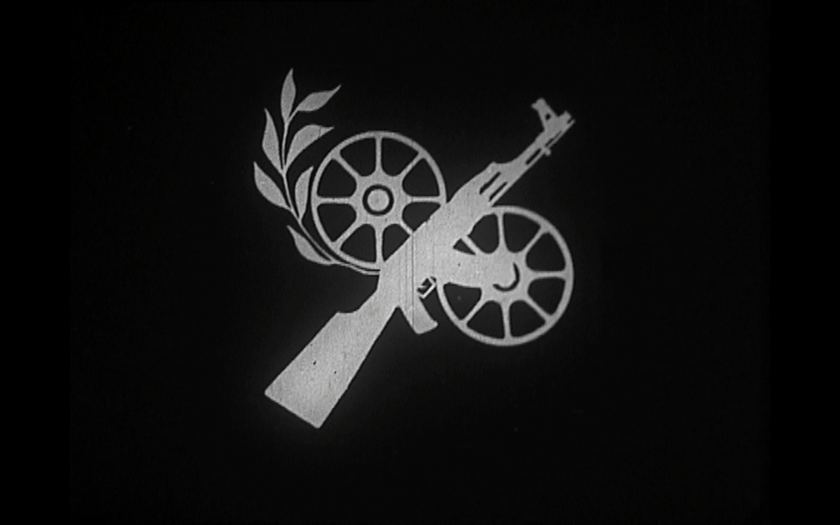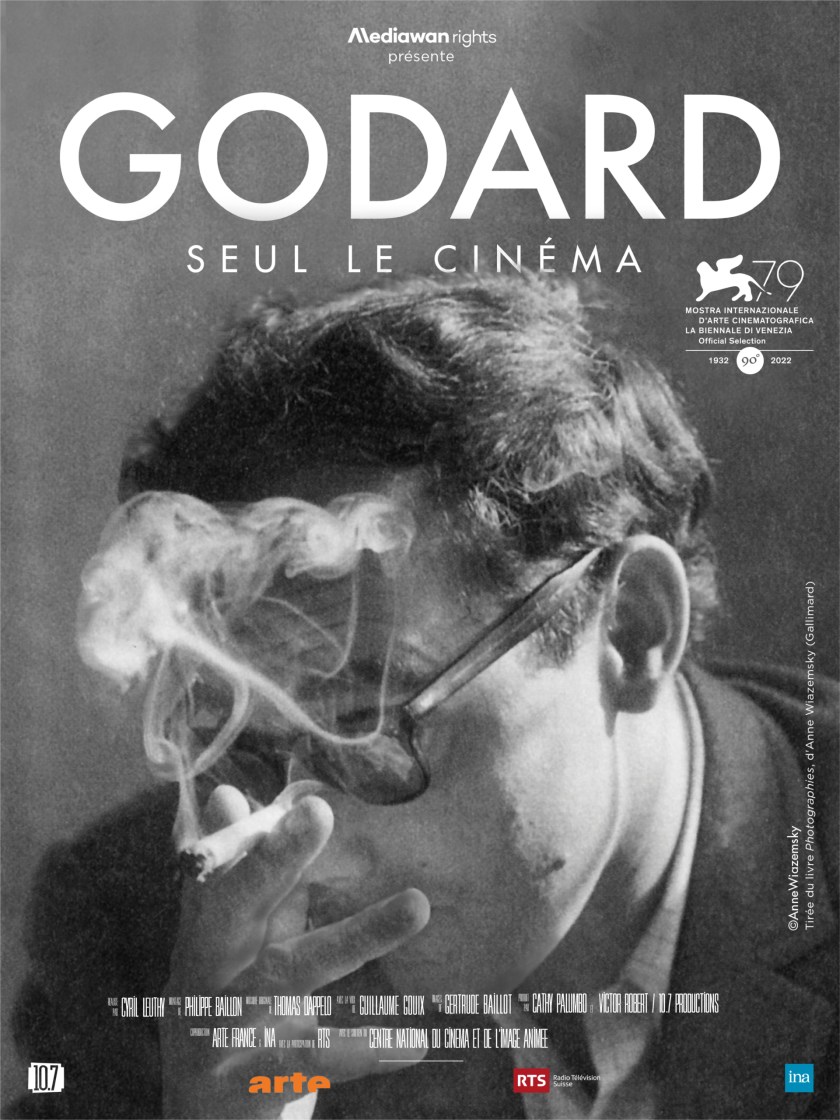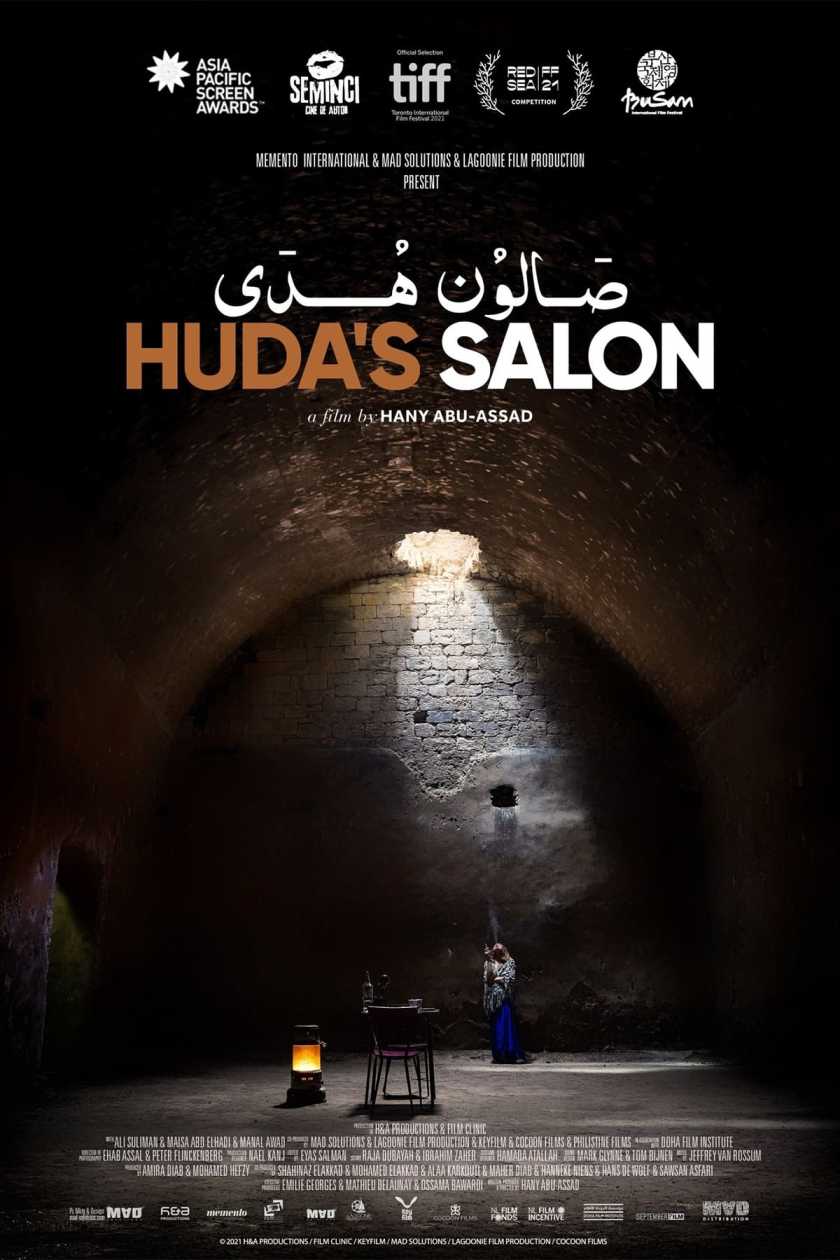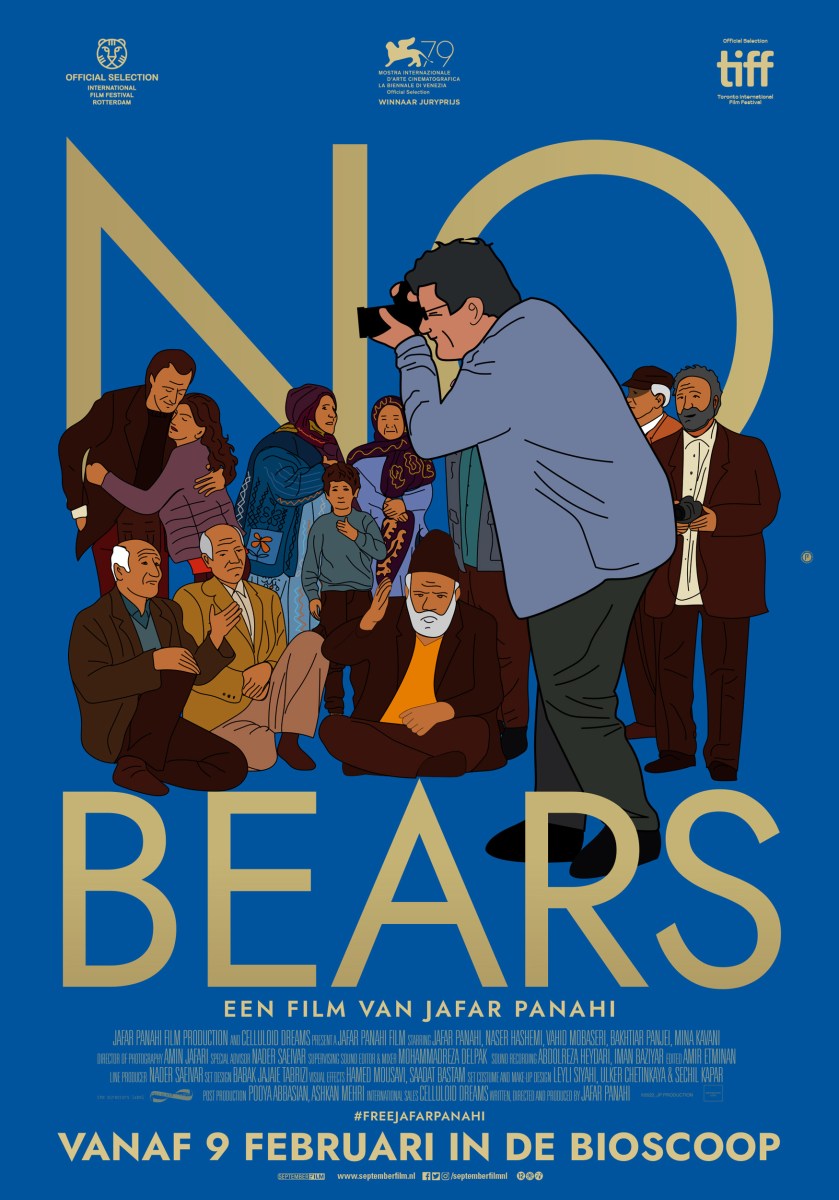“نجوم في الظهيرة” لكلير دوني… التفاف الفيلم على بطلته
أخرجت الفرنسية كلير دوني العام الماضي فيلمين، واحد في مهرجان برلين السينمائي نالت عنه جائزة أفضل إخراج، هو “مع الحب والشراسة”، نزل إلى الصالات الفرنسية وتناولتُه في مقالة وقتها (“القدس العربي 4/10/ 2022). الثاني في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، ونالت عنه الجائزة الكبرى، هو “نجوم في الظهيرة”. وقد يكون التوزيع سبباً في انتظار الثاني، موضوعنا هنا، لعام كامل كي ينزل إلى الصالات الفرنسية.