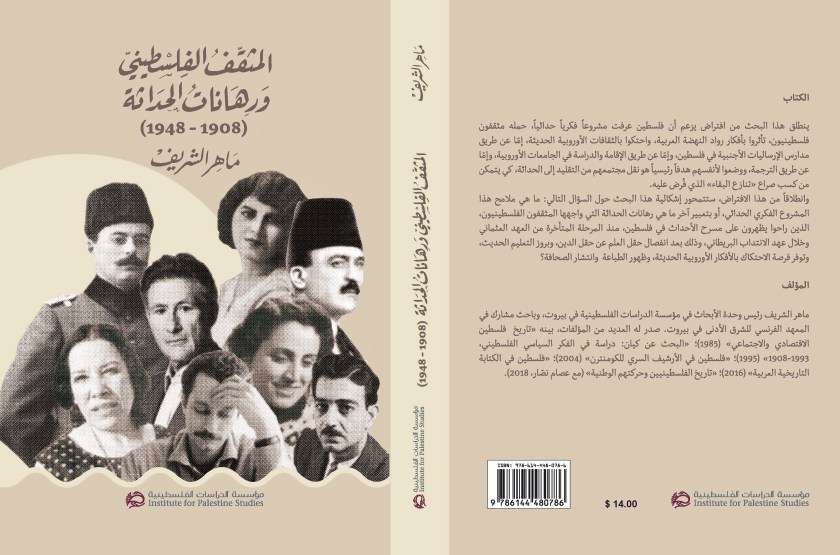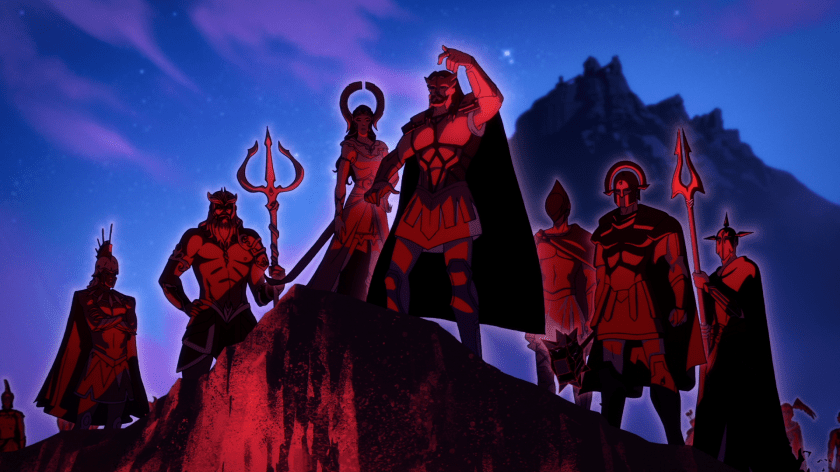«ملعونو الكومونة»… ١٥٠ عاماً على الثورة الباريسية
تتناول الأعمال السينمائية، روائيةً ووثائقيةً، الأحداث التاريخية بشكل متواصل، وكلّما علت تاريخيةُ الحدث تكثر تلك الأعمال، ذلك يتعلق طبعاً بكمية الإنتاج السينمائي في بلد تلك الأحداث، ونوعيته. في فرنسا مثلاً، حيث للسينما صناعة متقدمة، يسهل أن نجد أفلاماً عديدة تناولت الثورة الفرنسية، واحتلال النازية لفرنسا، والمقاومة الفرنسية (الشيوعية تحديداً) آنذاك، وثورة أيار ١٩٦٨، وكذلك، وبشكل خاص، كومونة باريس التي نمر هذه الأيام بذكراها المئة والخمسين.