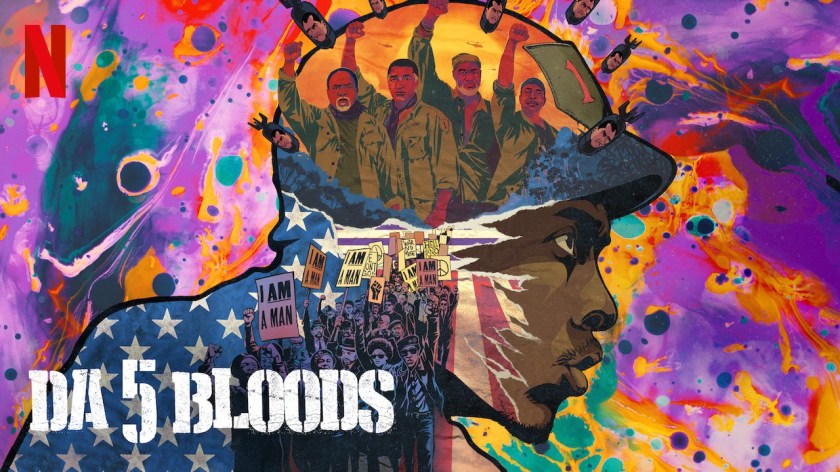آخر المقالات
لويس بونويل… السريالية في فانتازمات نهاريّة
هنالك تيارات في السينما، لها رموزها، روّادها ومن ثمّ المتأثرين بهم. وهنالك لويس بونويل، الإسباني الذي كان بمفرده تياراً، ودون متأثرين أو مريدين ينسخون، بأساليبهم، سينماه لخصوصية هذه السينما ربما وصعوبة نسخها. لكن، لهذه الخصوصية كذلك ولتمايز سينماه عن غيرها، يسهل إحالة مَشاهد هنا وهناك، بسياقات منفصلة، إلى أفلامه التي صار الكثير من مَشاهدها مرجعيات -وإن عصيّة- لغيرها. اقرأ المزيد
الكويرية فلسطينياً… لمَ قد نهتم بالموضوع؟
سُئلت “لمَ قد تهتم رمّان بالموضوع؟” حين ذكرتُ لصديقةٍ نيّتي فتح هذا الملف. فتساءلتُ “لمَ قد تتساءل صديقة عن اهتمام رمّان بالموضوع؟” ولستُ أكيداً إن وجدتُ إجابة، بعد. لكن، على الأقل، أدركتُ بهذا التساؤل مدى العزلة والنفي الذي تعيشه المسألة الكويرية في ظل طغيان مسائل أخرى تسيّدت كلّ ما هو ليس وطنياً بالمعنى المباشر والمطْمَئن، وأحياناً السطحي، للكلمة.
مَشاهد فلسطينية في أفلام لا علاقة لها بفلسطين
أي حديث عن “السينما الفلسطينية” يحيلنا تلقائياً (وليست الإحالة دقيقة) إلى صنّاع الأفلام الفلسطينيين، المنتمين بهويّة مطبوعة إلى هذا البلد. وبانفتاح أكبر على ما يمكن أن تعنيه “السينما الفلسطينية”، أو أي انتماء لهذه الصفة (الفلسطينية)، في مجال السينما مثلاً، وهو مبحَثنا هنا، يحيلنا الحديث عن هذه السينما إلى أفلام ينجزها غير فلسطينيين تكون فلسطين، كموضوع، حاضرة أساسية فيها.
قلق الروائي من قارئه… كالڤينو وأوستر ودوستويفسكي
يسمع الكاتب عبارات تأتي كتعليقات على نصوصٍ كتبها، روائية تحديداً، تتعلق بتفسير أصحابها للمكتوب، بتوقعاتهم لما كان “يُتفرض” أن يكونا مكتوباً، أو بعلاقة هذا المكتوب بمعارفهم وأمزجتهم وواقعهم.
لنتفق بداية على إمكانية أن يكون النص الروائي مفصولاً عن مؤلفه، فهو عملٌ مكتمل بذاته متى نُشر. وكاتبه لا مكانة له، إزاء النص، سوى كعارف -ربما- أكثر من غيره بمعاني النص وسياقاته، يقدمها خارج إطاره ودون أن تكون له سطوة على قراءات آخرين للنص المكتمل. لكن كذلك دون حاجة القارئ لاستفراد النّاقم/المنتقم بالنص بعدما أعلن الفرنسي رولان بارت “موت المؤلف” في كتابه «هسهسة اللغة».
“رمّان” كدياسبورا فلسطينية
ليس لاسم فلسطين ملامح مكتملة، هي ليست تلك الخارطة المعلّقة على صدور أهلها وجدران بيوتهم. هي تلك ومنفاها معها، الشقّة الأخرى، على الطرف الآخر من العالم، كل ما هو خارجها، بدءاً من أقرب المخيمات إليها.
«إيما»… الرقص كعنصر سينمائي
ليس بالضرورة أن يكتفي الفيلم، كعمل فني، بالجانبين الحكائي والبصري فيه، يُختصر بهما الفيلم، أو تُختصر بهما مجالات تقييمه من قبل متلقيه، كعنصرين أساسيين لذلك، وهما فعلاً أساسيين. اقرأ المزيد
ملفّنا “أنطونيو سكارميتا”
نفتتح غداً ملفّنا عن الروائي التشيلي أنطونيو سكارميتا، بإحاطة لحضور صاحب الكتابة السينمائية والشعرية والسياسية، في اللغة العربية، وذلك بتعاون مع “دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع”.
النساء كقوّامات في مسلسل “مارتشيلا”
لكثرة الأفلام والمسلسلات التي تتناول عمليات تحقيق في جرائم متسلسلة، مدخلةً في ذلك الجانب الحركي كالملاحقات والمداهمات، والجانب السيكولوجي كتحليل بواعث العمل الإجرامي واستقراء القادم منها، والجانب التشويقي الدامج بين الجانبين السابقين والممتد على طول الحكاية معتمداً على الصوت والصورة كما هو على الحوارات والسيناريو، لكثرة هذه الأفلام والمسلسلات وتشاركها في الجوانب الثلاثة، بنسب متفاوتة، تتفاوت في التناول وتتفاوت في الجودة كذلك، لا بد أن يتساءل أحدنا عن الجدوى من عمل جديد يمكن بسهولة أن يكون تناسخاً آخر بين هذه الأعمال وبين بعضها، لا بد أن يتساءل إن كانت هنالك رغبة مستمرة في مشاهدة مسلسل ممثال لآخر نال إعجابه.
النكبة كموضوع “غير مفضّل” للسينما الفلسطينية
في نقاش السردية الفلسطينية ومدى ندّيتها للسردية الإسرائيلية في الأعمال الفنية (أدباً وسينما…)، ومدى استحقاقها لهذه الندية، ونحن أمام ماكينة صناعية وترويجية ضخمة يمتاز الاحتلال بها عنا، يأخذنا الحديث مباشرة إلى السينما الفلسطينية، حيث لا بد من حكايات تستقوي بها السردية، وحيث لا بد أساساً من حكاية النكبة، الأصل الذي تحوم حوله كل القصص الصغيرة المساهمة في صناعة هذه السردية.
البورتريه الذاتي وحالاتُ ڤان خوخ المتطرّفة
“البورتريه هي شيء قديم -قد قول البعض- لكنها أيضاً شيء جديد تماماً”. هذه العبارة للرسام الهولندي ڤينسنت ڤان خوخ، المكثر من البورتريهات، وهو الذي قال كذلك إن “البورتريه مسألة مشاعر”، وهو من ذلك -وإليه- مكثر في مشاعره، كثرة نراها في لوحاته التي تموج فيها المشاعر كالغربان والرياح والسنابل (في لوحاته)، ونقرأها في رسائله إلى أخيه تيو، ونعرف عنها من سيرته.
الخيال الذاتي في أفلام فرانسوا تروفو
الخلط لدى مشاهدي أفلام الفرنسي فرانسوا تروفو في بدايات تعرّفهم إليه، بينه وبين الممثل جان بيير ليو، لا يقتصر عليهم كمشاهدين متلقّين من بعيد (كعربٍ مثلاً) رأوا وجهين متشابهين، بنتيجةٍ لهذا التشابه هي شخصية أنطوان دوانيل، التي كتبها و أخرجها الأوّل وأدّاها الأخير.
فلنحرق “دليل تركيب الفيلم الفلسطيني”
قد يكون في ما فعلته مؤسسة “فيلم لاب: فلسطين” مع صنّاع أفلام فلسطينيين إيقاعاً لهم في إغراء استسهال صناعة فيلم بخمس دقائق، وفي مدّة “أوّلية” هي أسبوع. هو إغراء من ناحية، تبيّن ذلك في استسهال العديد من هؤلاء في “إخراج” الدقائق الخمس هذه، وهو تحدٍّ من ناحية أخرى بان كذلك في أفلام قليلة من بين الأفلام الثلاثة عشر التي أطلقها موقع المؤسسة على ثلاث مجموعات (منعت وزارة الثقافة الفلسطينية ما كان يفترض أن يكون فيلماً رابع عشر).
«ملح الدموع»… الحب كمسألة تفصيلية
ينقل الفرنسي فيليب غاريل في أفلامه الأخيرة حكايات تبدو متسلسلة، شكلاً ومضموناً، فهي مصوّرة بالأبيض والأسود، بأسلوب مايزال مخلصاً فيه غاريل “للموجة الجديدة” الفرنسية، بتصوير واقعي، في الشوارع ومع الناس، وباريس حاضرة دائماً، بميزانية صغيرة وممثلين غير نجوم. هذا شكلاً، أما موضوعاً، فهي قصص، أو مجتزآت من قصص حب، علاقات تنتهي وتبدأ، تتداخل وتتعدد، والتعدد هذا حاضر في أفلامه الأخيرة في أكثر من قصّة/فيلم. اقرأ المزيد
«شقيقة موسوليني»… راهنيّة الماضي في النّاصرة
في الفيلم الرّوائي يصنع السيناريو الشخصيات، في الوثائقي تصنع الشخصياتُ السيناريو، تصنع الشخصياتُ الفيلم، يتبعها صانع الفيلم في وقتٍ تتبع الشخصياتُ الصّانعَ في الرّوائي.
«ترامواي في القدس» للإسرائيلي عاموس جيتاي
لعاموس جيتاي أفلام عديدة متراوحة بين الوثائقي والروائي، وهي سياسية في عمومها. أتى فيلمه الأخير ليدمج بين الوثائقي والروائي، وكان سياسياً تماماً. أما السياسة فيه فكانت استمراراً لمواقف جيتاي الرمادية المتخللة أفلامَه السابقة، وأما الدمج فكان لخلو الفيلم من حكاية، فكان أشبه بتثبيت كاميرا في عربة ترامواي يقطع القدس بين شرقها وغربها لتوثيق ما يدور فيها، فندخل في أحاديث ركاب العربة «المتنوعين»! اقرأ المزيد
السينما الروائية الفلسطينية… حكايات ناقصة
في الحديث عن السينما الروائية الفلسطينية، وكما يغلب التفاؤلُ التشاؤمَ في جوانب، يغلب التشاؤمُ التفاؤلَ في غيرها، وهذه سينما تتقدّم في ما يُعرف بسينما المؤلف، وإن بنسب متفاوتة، لكنها تتأخر في مسائل أخرى تتعلق بالشّق الروائي منها: الكتابة/السيناريو/الحكاية.
السينما الفلسطينية… من الأفراد إلى المؤسسات
المسائل المطروحة للنقاش حول السينما الفلسطينية لا تنتهي، وأقول إنّ لدينا سينما فلسطينية وليس أفلاماً وحسب، وهذا بذاته موضوع نقاش، لكن الكم والنوع يسمحان بذلك القول، أما الأهم في هذا السّماح فهو تماثل الموضوعات، هو الهوية الموضوعاتية، ونوعاً ما البصرية، وكذلك الأسلوبية إن أشرنا إلى إيليا سليمان وتأثيره أسلوبياً على آخرين. اقرأ المزيد
لا بالإخفاء ولا بالاحتفاء… كيف نتلقى الأعمال الفنية المسيئة؟
قرأنا قبل أيام خبر حذف فيلم «ذهب مع الريح» من منصّة HBO، تزامناً مع التظاهرات التي رافقت مقتل جورج فلويد والمنادية بشعار “حياة السود مهمة”، وذلك للمحتوى العنصري لهذا الفيلم. بعدها بيوم قرأنا خبراً بأن الفيلم ذاته، إثر انتشار الخبر الأول، قد قفز إلى الأعلى مبيعاً في موقع “أمازون”. أخيراً، قرأنا خبراً عن إعادة المنصّة للفيلم إنّما مرفقاً بفيلمين توضيحيَّين ونقاشيَّين يتناولان البعد العنصري فيه. اقرأ المزيد
فيلم آخر عن حرب فيتنام… من وجهة نظر السود
ليس المخرج الأمريكي سبايك لي في صف المخرجين العظام، كفرانسيس فورد كوبولا وستانلي كوبريك وبنسبة أقل مايكل تشيمينو، والحديث هنا عن مخرجين لأفلام تناولت الحرب الأمريكية في فيتنام. لكنّه حاور هؤلاء وغيرهم في الزاوية التي نظر من خلالها إلى تلك الحرب، وكانت ضرورةً سردياً لكل تلك الحكايات في أفلام هؤلاء، وإن أتى الفيلم بمستوى أقلّ سينمائياً.
البيت والطريق إليه في «إجرين مارادونا» لفراس خوري
ليس من السهل حمل فكرة فلسطينية، ترسّخت في الذهن الفلسطيني، إلى فيلم قصير أبطاله أطفال ومجاله كرة القدم.
كأي عمل فني، يمكن قراءة فيلم «إجرين مارادونا» للفلسطيني فراس خوري بتأويلات عدة، بإحالات يمكن (جداً) أن لا يكون للسياق الفلسطيني أي حضور فيها، وإن احتوى الفيلم على أغنية من الثورة الفلسطينية تقول: ثوري ثوري يا جماهير الأرض المحتلة، أغنية ثورية صارت جزءاً من التراث الفلسطيني الحديث. هي جدّ فلسطينية لكنّها أتت لترافق تصويراً وقصّةً لا “فلسطينةَ” جاهزة فيهما. اقرأ المزيد