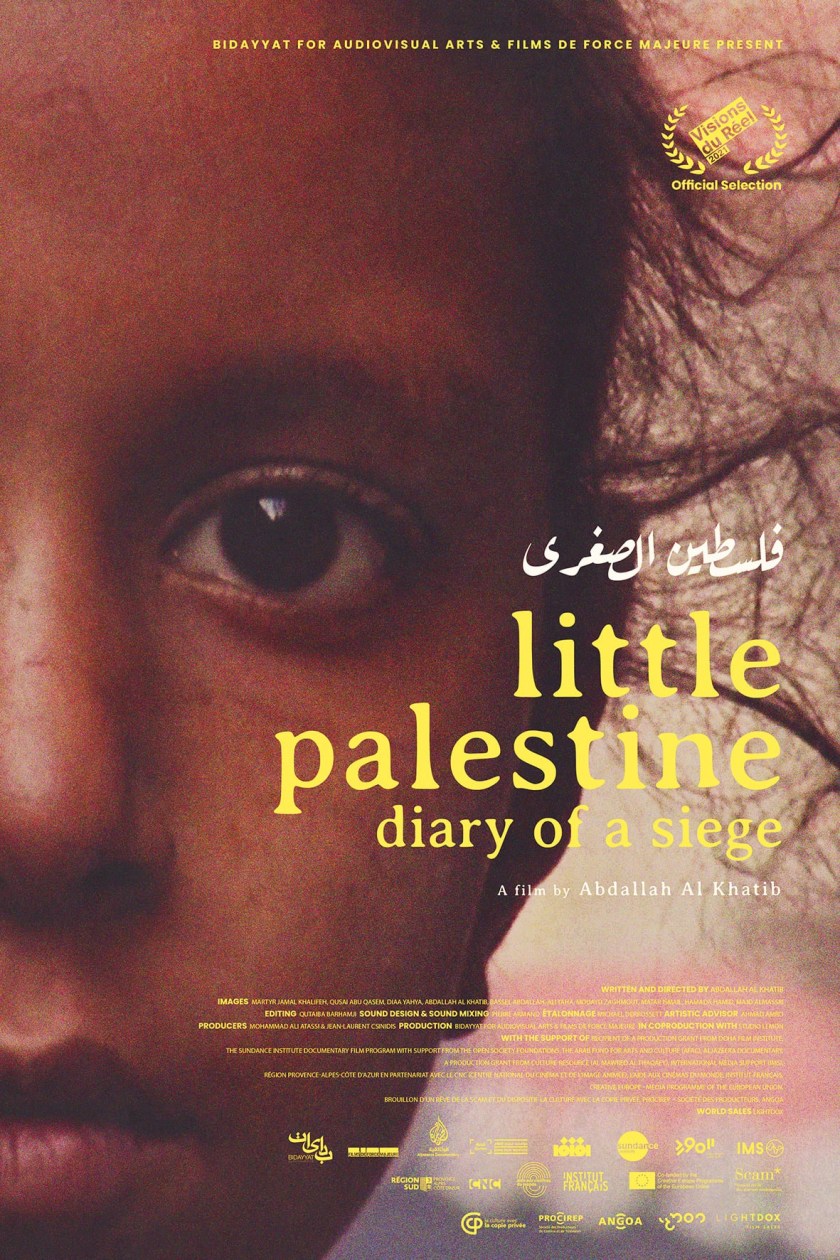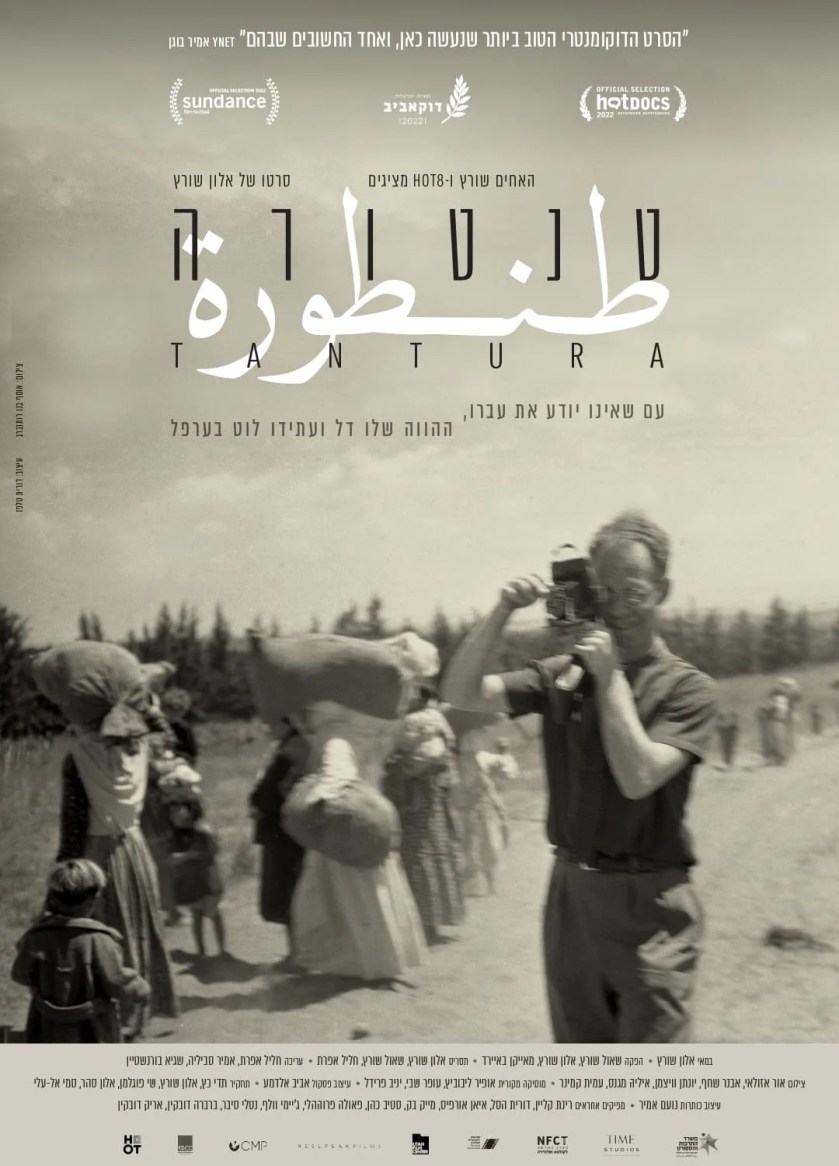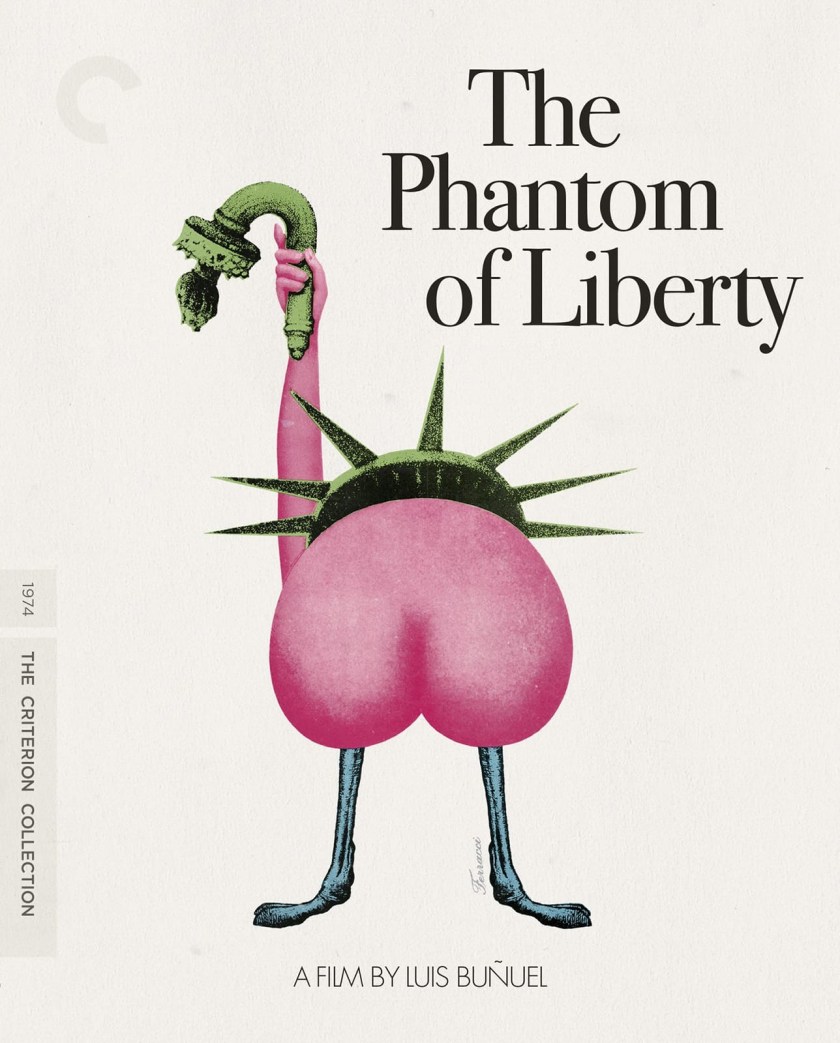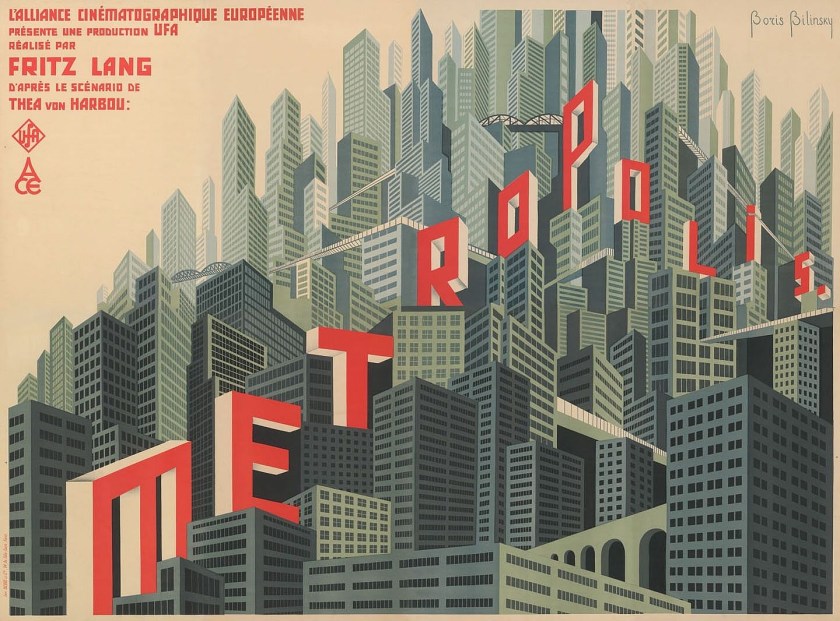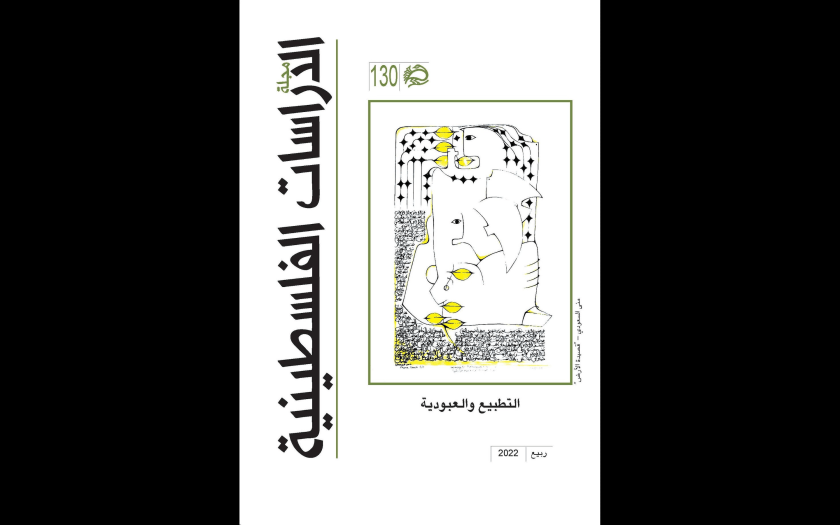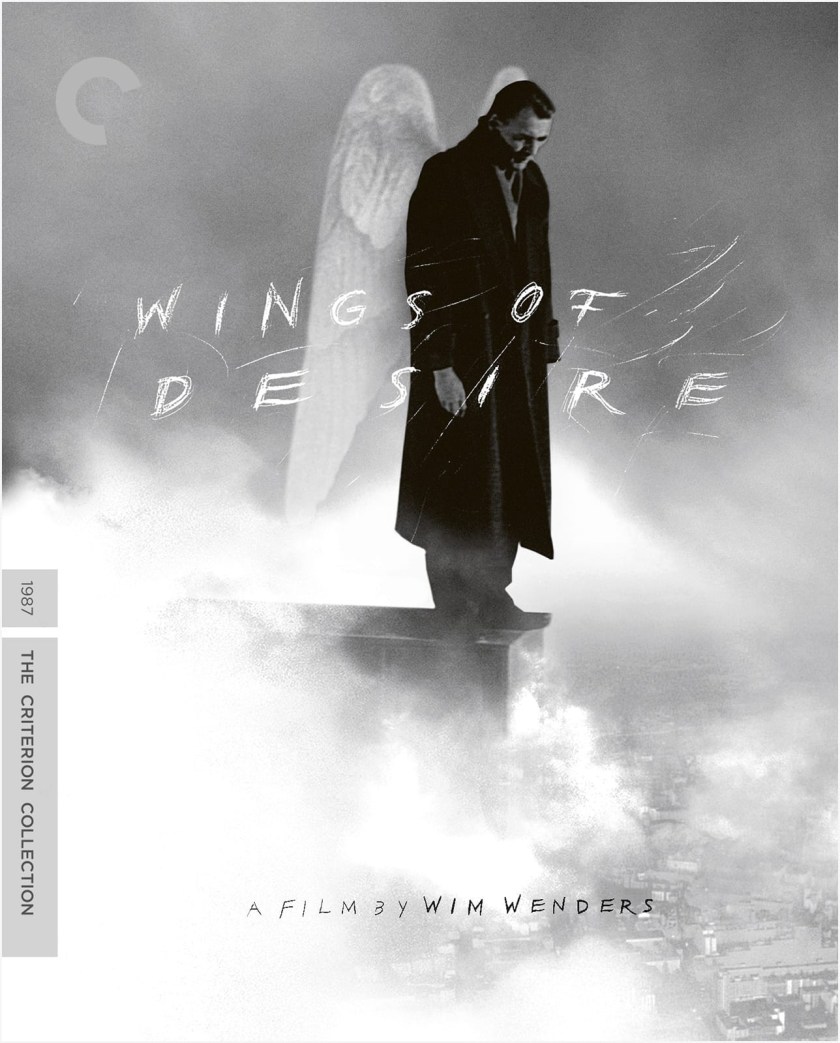“مهرجان رفكين” لوودي ألن… فيلم أوروبي آخر
صار وودي ألن عالة على نفسه، أو صارت أفلامه عالة على عموم منجزه السينمائي. لا يحط الكلام من قدر فيلمه الأخير “مهرجان رفكين”، بل هو للقول إن إرث ألن السينمائي، حمّل كل جديد له ذلك الثقل المتراكم كمياً بغزارة إنتاج خاصة، والمتراكم نوعياً إذ لا يمكن تحييد بعض أفلامه، في السبعينيات والثمانينيات تحديداً، عن أي حديث عن أفلام طبعت سينما القرن العشرين. استسهال ألن في صناعة الأفلام، بشكل شبه سنوي في العقدين الأخيرين، قلل من قيمتها في مقارنتها مع سابقاتها. وهذا ما يتوجب الانتباه إليه في تقييم كل جديد لألن. إذ لا يمكن توقع “آني هول” آخر مع كل جديد، خاصة أن أفلام العقد الأخير تتالت ضمن أسلوب واحد ومواضيع وشخصيات متماثلة، كأنها، كلها، في مبنى واحد حصل فيه هذا الفيلم اليوم وذاك غداً.