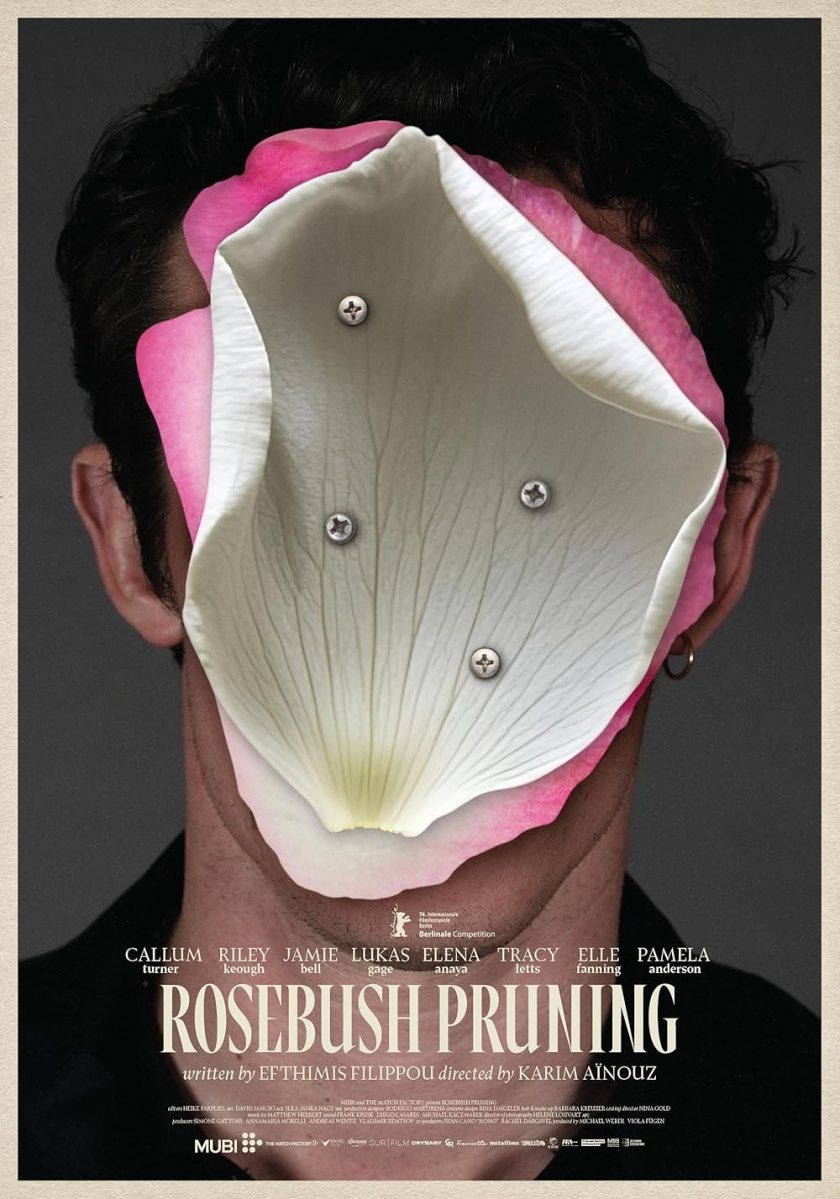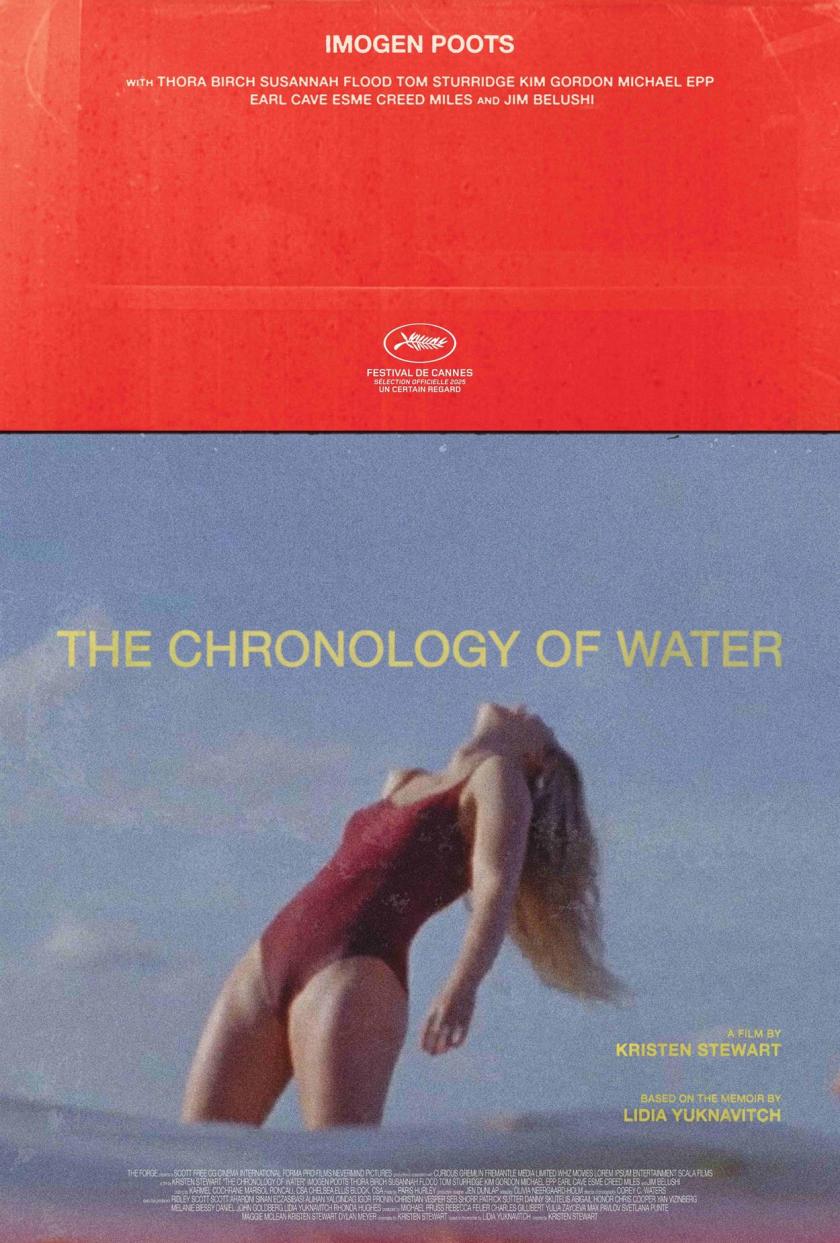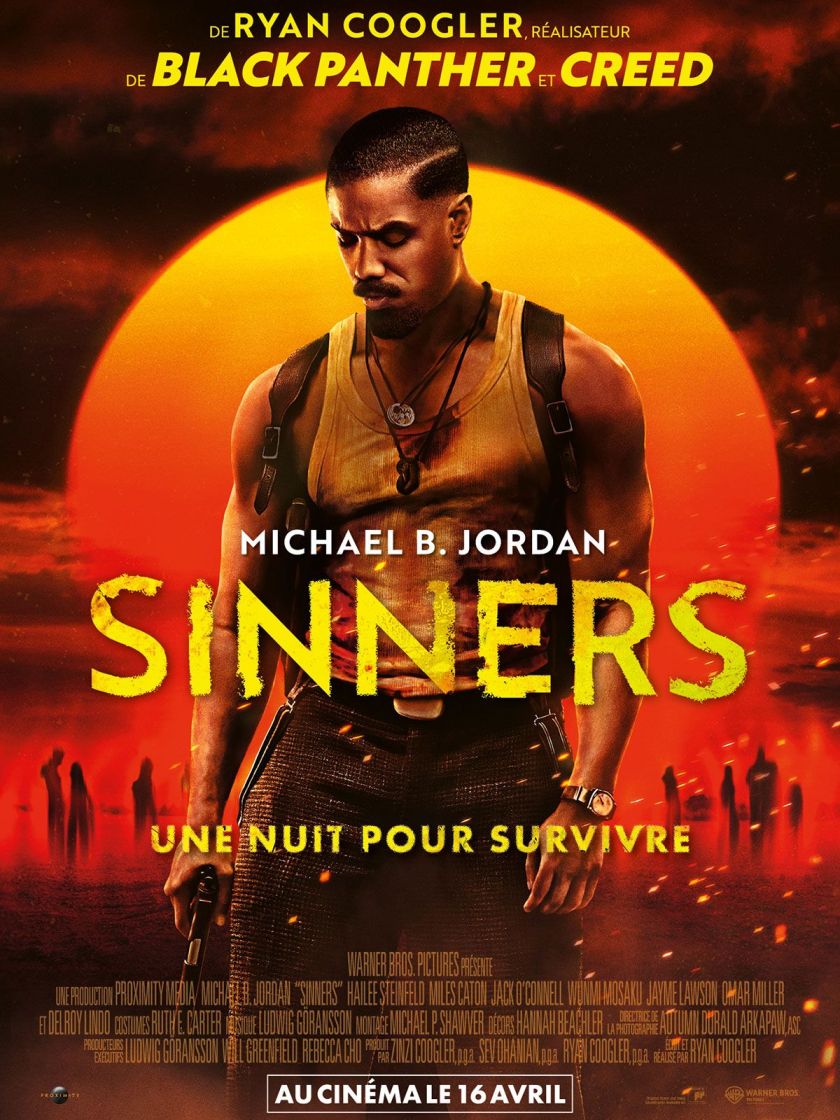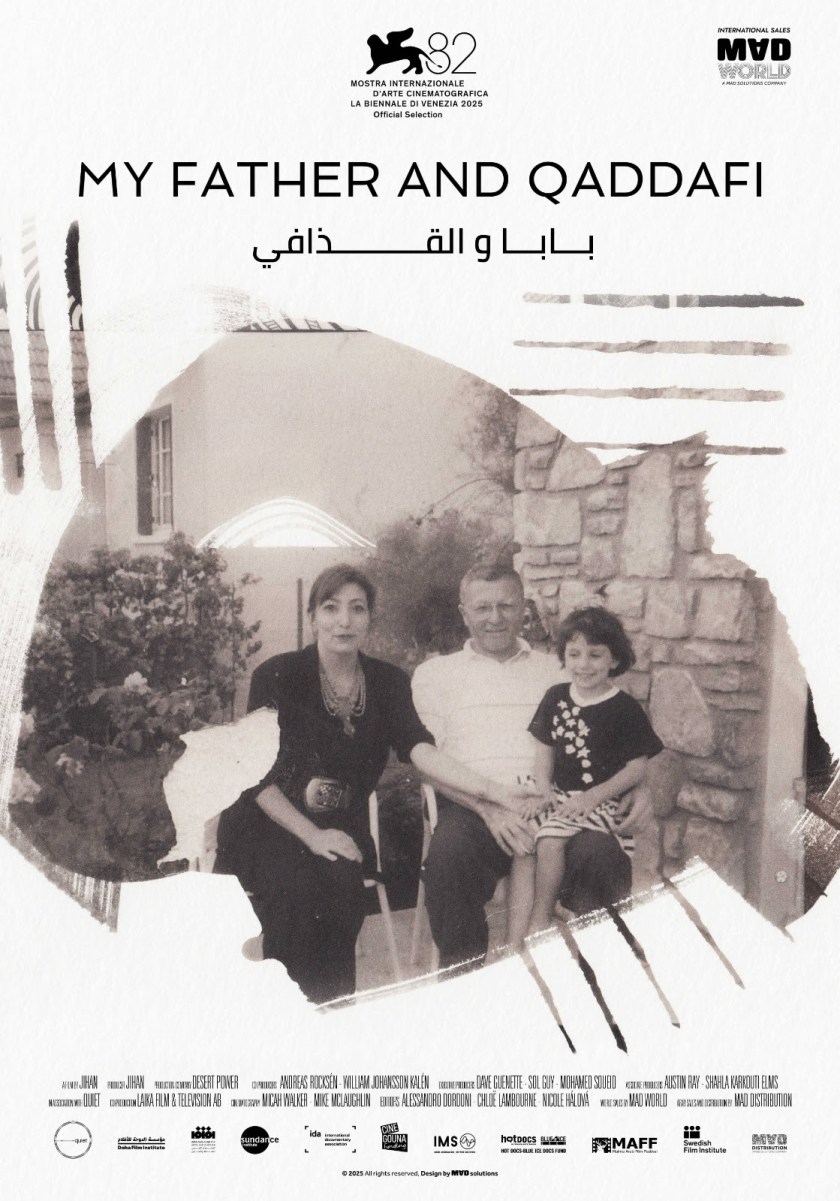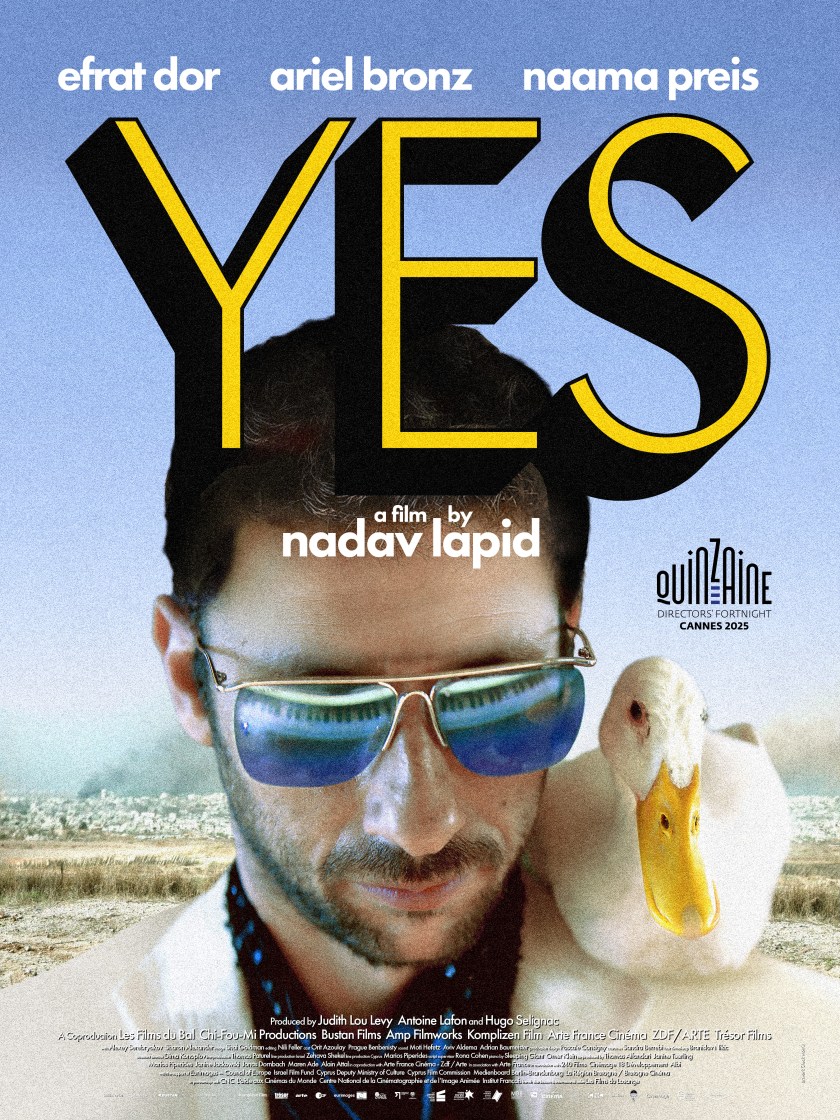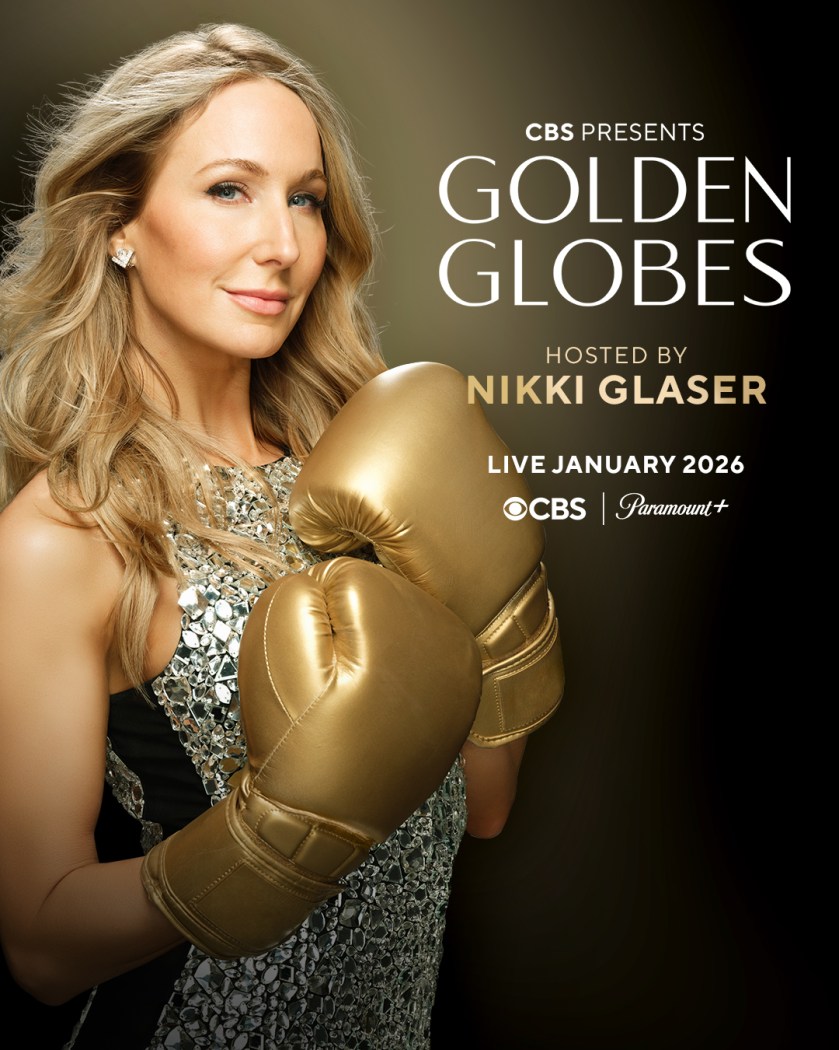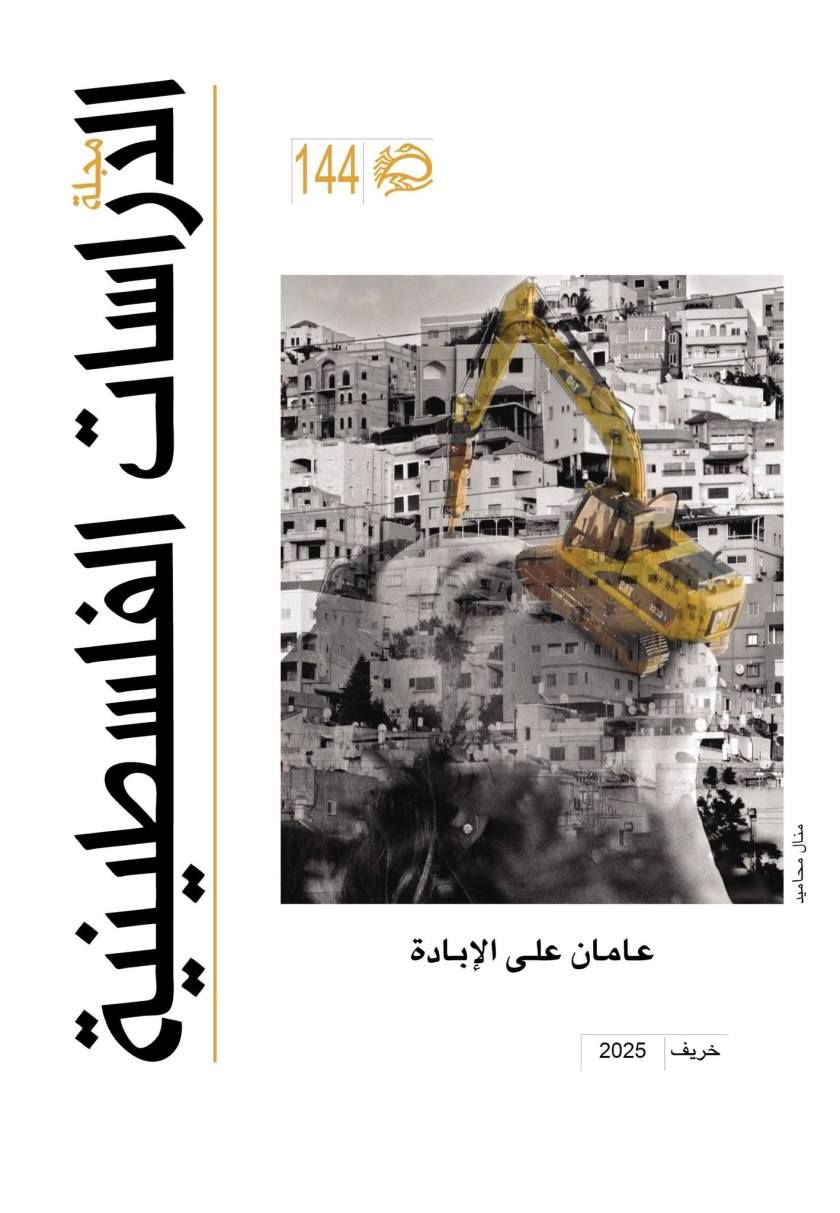“المعرض العام” في كارتييه للفنون المعاصرة… الفن سلعة فاخرة
بقعة مظلمة حلّت على العاصمة الفرنسية في الخريف الفائت. لم يتعوّد المارّة من أمام مركز بومبيدو رؤيته كتلة صمّاء ومعتمة، ضخمة كأنها بناء مهجور، اختفت ألوانه وطغت الأعمدة الفولاذية. أغلق المركز أبوابه، وهو متحف للفنون الحديثة، لعمليات ترميم شاملة كي يُعاد فتحه في ٢٠٣٠.