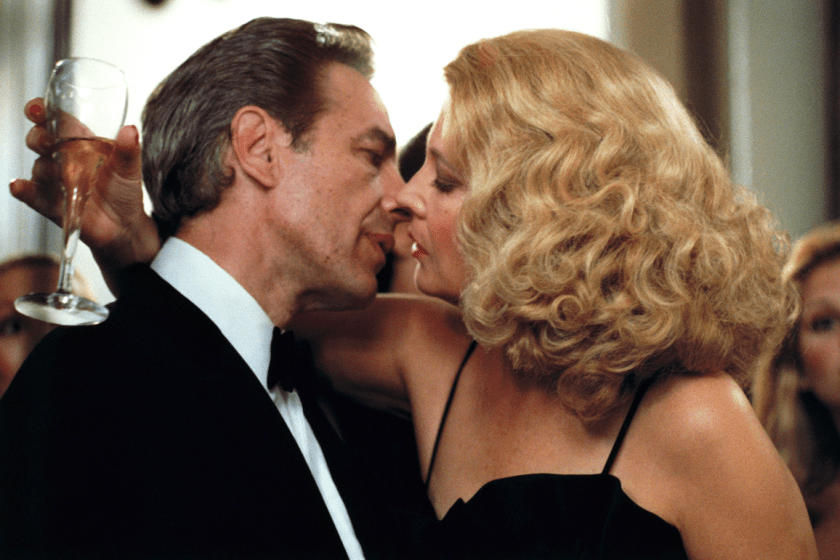«روما» للمكسيكي ألفونسو كوارون
السينما -في أحد أوجهها- صناعة، وجزء من هذه الصناعة هو التسويق. كأي منتَج، لا يمكن للفيلم أن ينال فرصةً للتقييم، كفيلم جيّد أو لا، أو مدى ذلك، دون الوصول، دون وصوله إلى مشاهدين من خلال مهرجانات وشاشات. هذا هو حال الفيلم المكسيكي «روما» الذي توزّعه شبكة نتفليكس، وبالتلي يتلقاه أحدنا من خلال شاشة (تلفزيون، كمبيوتر، تليفون…).