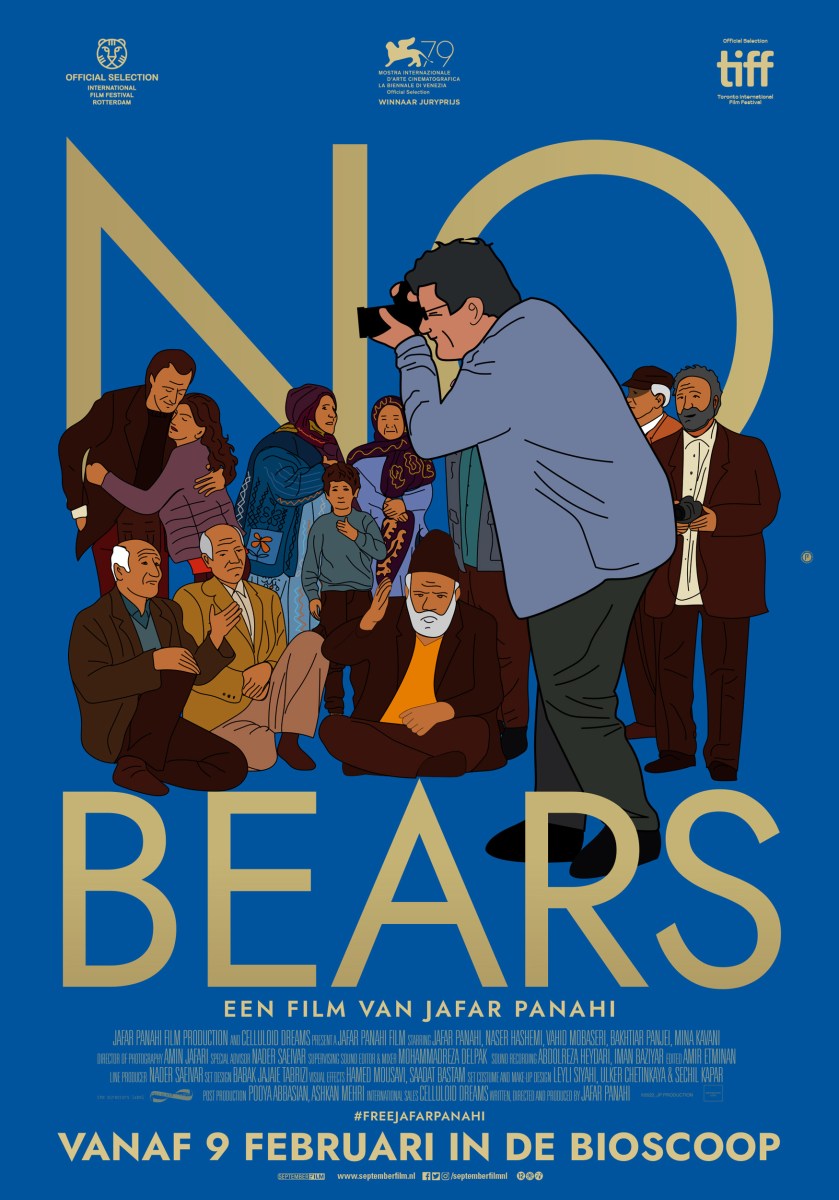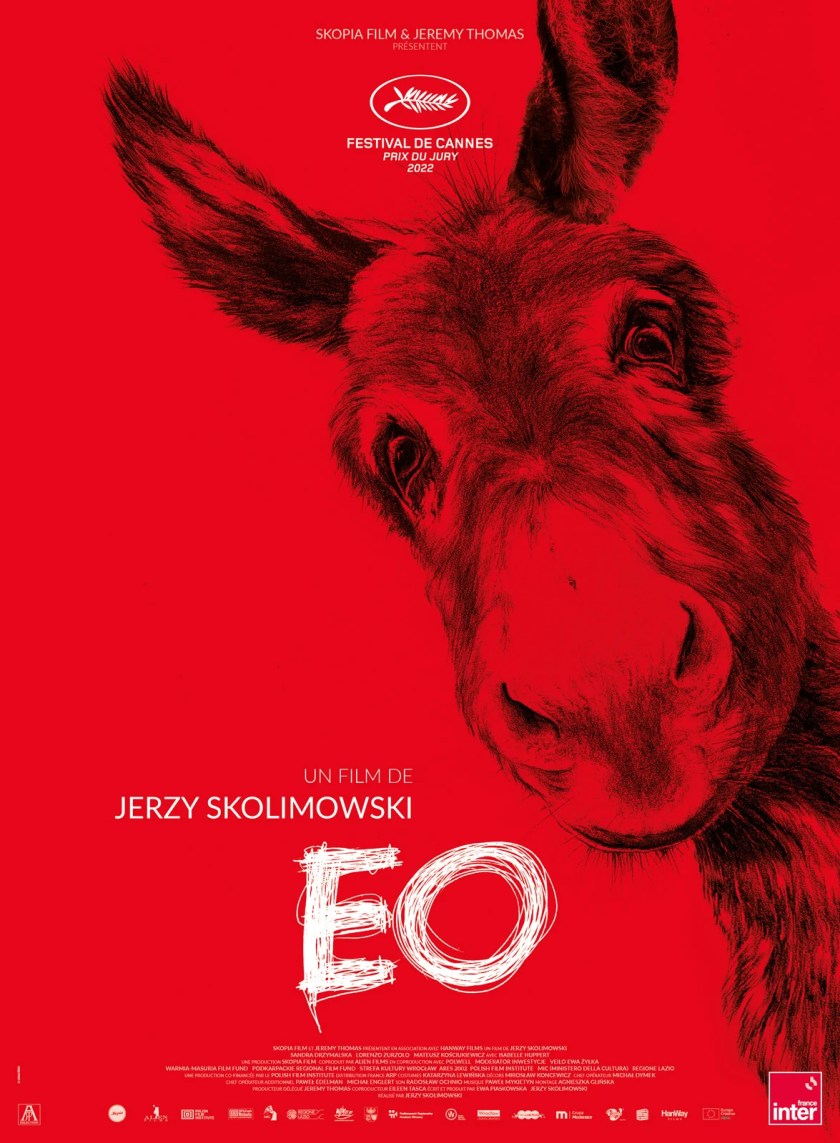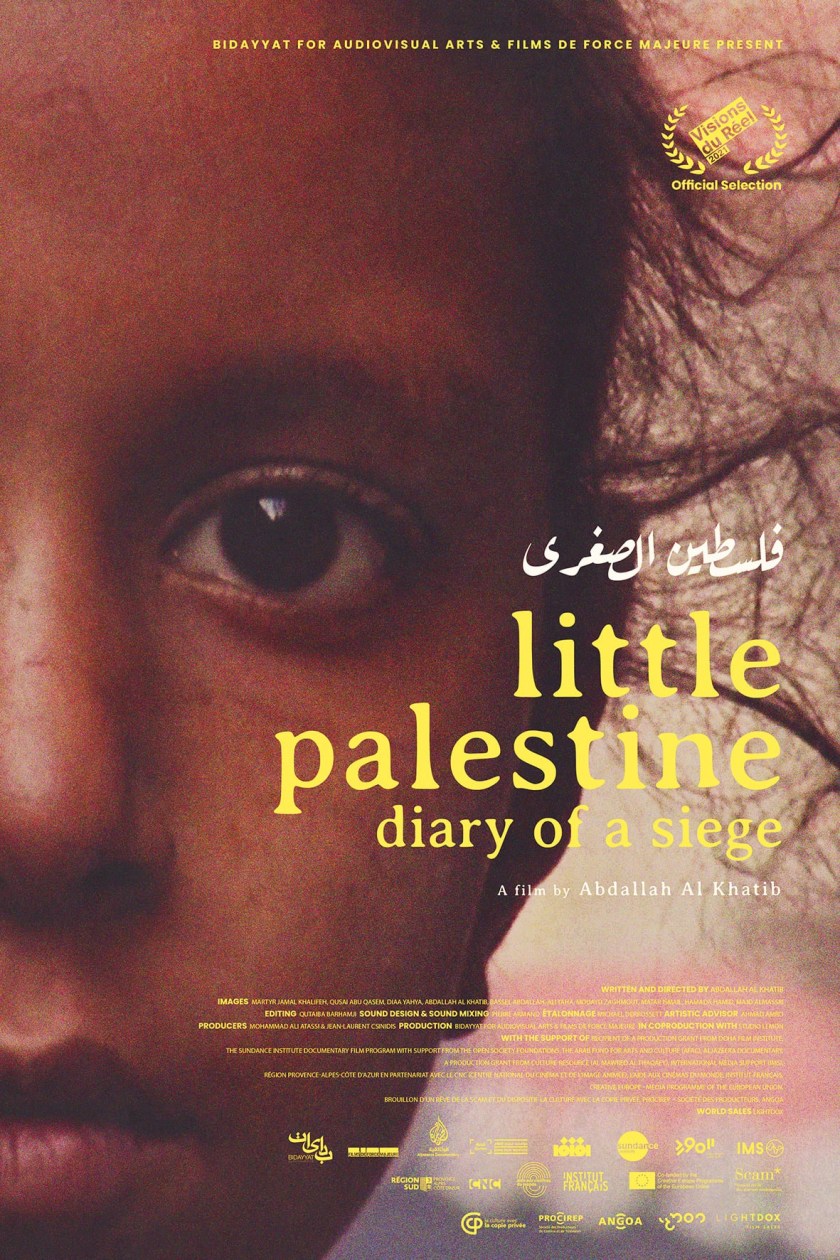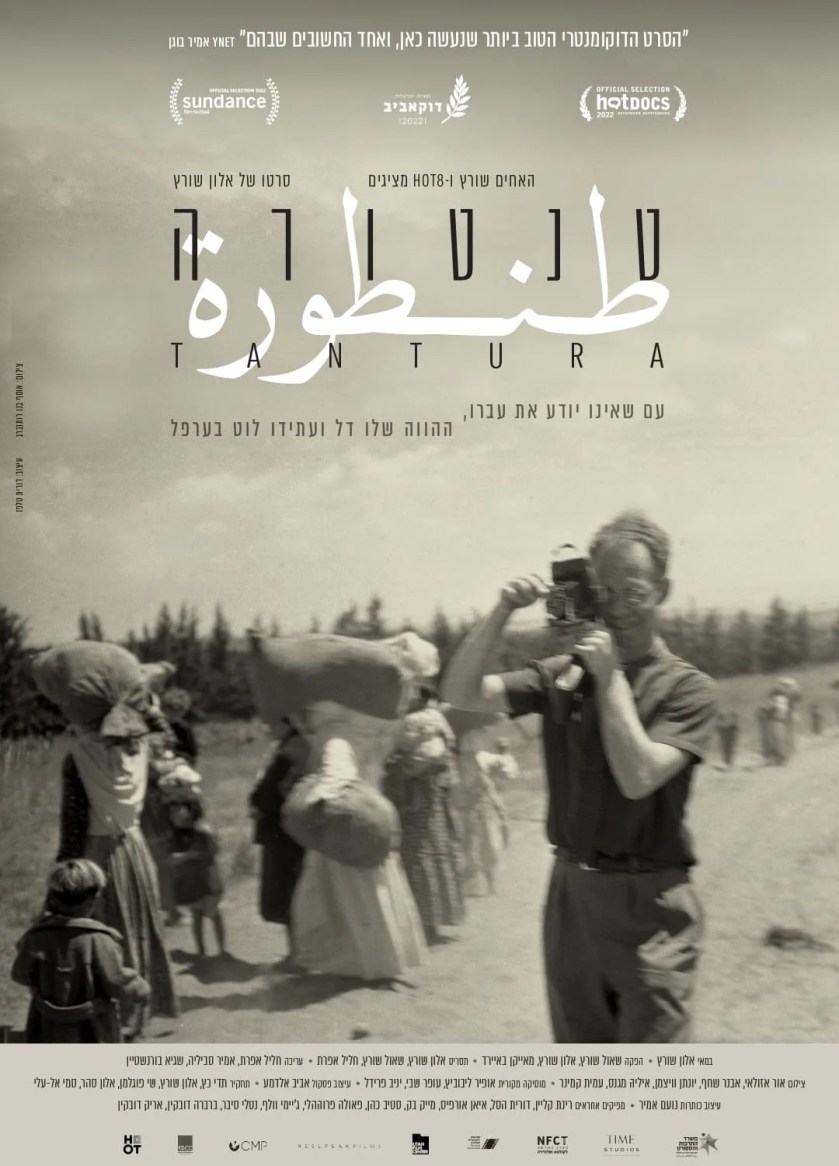“تـ(و)ـاريخ السينما” لغودار… السردية كما يجب أن تُفكَّك
خسارة سينمائية كبرى شهدها العام الماضي، رحيل أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما، جان لوك غودار، لاستثنائية تجربته وغناها وامتدادها في أفلام متفاوتة، كماً ونوعاً. لغودار ذاته مكانة خاصة بمثابة التلخيص لتاريخ سينما العالم، من خلال مرحلته التأسيسية منذ “الموجة الجديدة” حتى آخر أفلامه التجريبية، مروراً بمرحلته الثورية والماوية، المكانة هذه تجمع ما بين الفيلم المستقر في نوعه، الصالح للصالات والمهرجانات الكبرى، والفيلم القلق في نوعه، شديد الفنية والتجريبية، الأقرب إلى الفيديو آرت الطويل الصالح لمعارض الفن المعاصر.