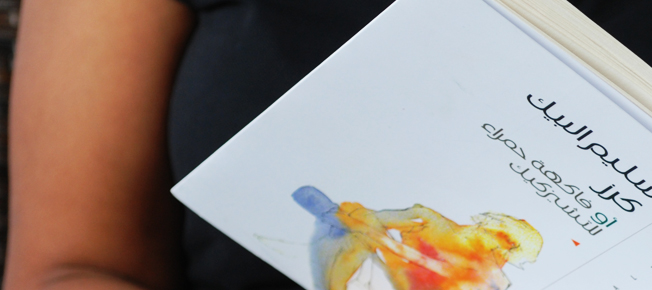نسرين فاعور: لا بدّ من تحديد ما هو «التطبيع» فلا تطال «مكافحته» السينما الفلسطينية.. حوار
استطاعت الأفلام الفلسطينية أن توجِد لنفسها مكانة في السينما العربية، نستطيع القول أنها مكانة متقدّمة نسبياً من الناحية الفنيّة وكذلك الدرامية. يمكن إرجاع ذلك لعدّة عوامل سيكون من بينها حتماً الظرف السياسي والاجتماعي الذي يعيشه الفلسطينيون، وللغنى الذي يمكن أن تقدّمه القضيّة بما تكتنفه من موضوعات، لأي عمل فنّي أدباً كان أم سينما.