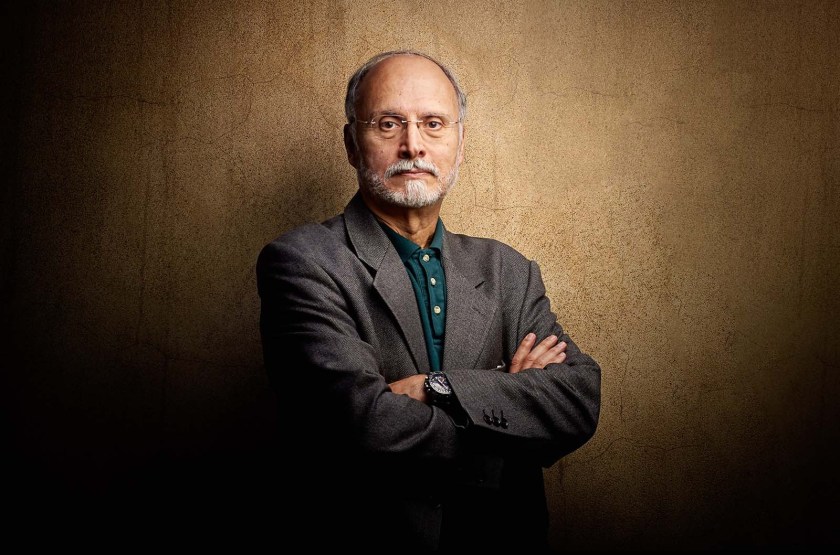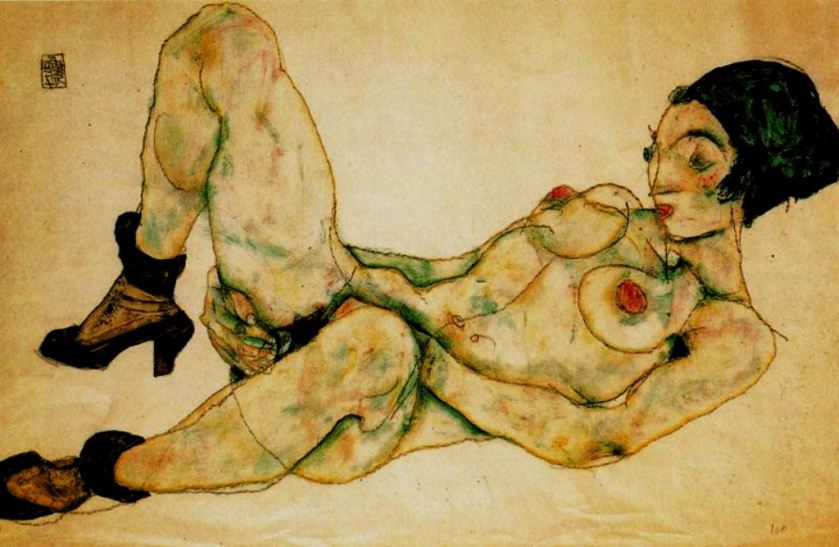رسائل “كان”: نهيمُ على وجوهنا
لسنا مكاناً، لسنا حدوداً، لسنا دولةً، لكنّنا حاضرون، ومعنا تحضر ثقافتنا وفكرتنا عن الوطن والانتماء إليه، لم يعتد الفلسطينيون مكاناً خاصاً بهم، مكاناً يدخلون إليه. نحن خارجون دائماً، لا نجدُنا سوى خارجين عن أمكنتنا، مبعثرين في أمكنة الآخرين. جُملة درويش صارت شعاراً ينكر به الفلسطينيون الحالة القائمة في أنّ “وطني حقيبة” بنفيها، لفظياً، شعرياً، مجازياً، لأنّ الوطن، فلسطينياً، حقيبة. كان كذلك وما يزال. هو الراهن المستنسِخ لذاته، للفلسطيني منذ الخروج الكبير عام النكبة، منذ الترحال الأوّل. متى وجدنا مكاناً يجمعنا، يتلاشى كالغبار. نُبقي حقائبَنا على ظهورنا، نهيم على وجوهنا. كذلك كان الفلسطينيون في مهرجان كان لهذا العام، لا مكان يجمعهم، لا جناح يأويهم كالخيمة، أشبه بحالهم التي تعوّدوها، حقائبهم على ظهورهم، متنقّلين بين أمكنة الآخرين، أصدقاء لهم وغرباء عنهم. تعوّدُ هذه الحال ليس حسناً، ليس اختياراً، التكيّف مع الترحال ليس امتيازاً، لكنّ فلسطين هي الفلسطينيون (وفنّهم)، هي أين تواجدوا، هي الفكرة التي يشكّلها هؤلاء بحضورهم أين كانوا، هي كلّ هؤلاء معاً، بفنونهم، هذا ما شعرتُه في المهرجان الكئيب من ناحيته الأخرى، كأنّ عرساً عالمياً يمتدّ لأيّام، ينتشر الفلسطينيون فيه، حقائبهم على ظهورهم، يحكون بمشاريعهم وأفلامهم عن …